نايف خوري: الحركة المسرحيّة الفلسطينيّة في الجليل

نايف خوري – حيفا – 10.6.2025
الحركة المسرحية الفلسطينية في الجليل
الحركة المسرحية العربية:
إذا كان مارون النقاش اللبناني قدّم أول مسرحية باللغة العربية عام 1847، في بيته في بيروت، وكانت ترجمة لمسرحية البخيل لموليير. فإن المسرح العربي الذي نعرفه اليوم تأسس في سوريا على يد أبو خليل القباني، وبعده عرض يعقوب صنوع في مصر أول مسرحية عام 1876، بينما ظهرت أول مسرحية عربية فلسطينية في القدس نحو عام 1910، حيث قدم المنتدى الأدبي برئاسة المرحوم جميل الحسيني مسرحية “صلاح الدين” تحت رعاية الملك فيصل.
ثم عرض هذا المنتدى روايات أخرى مثل “السموأل”، “طارق بن زياد”، “هاملت”. وعهد بأداء الأدوار النسائية في حينه إلى شبان صغار السن، قبل أن تنمو شواربهم ولحاهم. ثم عرضت مسرحيات على مدار سنوات تالية في مدرسة المطران بالقدس ومن أهمها مسرحية “لصوص الغاب” لنيتشة عام 1916.
ولا نغفل عن الدور الذي قام به الأرشمندريت استفان سالم، من الناصرة وعمل في مدرسة تيراسنطة في القدس، وقد وضع عددًا من المسرحيات التي ظهرت على المسرح المدرسي، مثل: “سجناء الحرية”، “غرام ميت”، “صديق حتى الموت”، “الموسيقى خير علاج”، “دقت الساعة يا فلسطين” وغيرها.
وكتب عدد آخر من الأدباء في فلسطين مسرحيات متنوعة مثل “أسمى طوبي” من عكا و”جميل البحري” من حيفا. وعادت الحركة المسرحية إلى القدس ليقيم “صليبا الجوزي” مسرحًا اجتماعيًا، وقدّم مسرحيات وضعها الجوزي في عام 1927.
ولكن نظراً لعدم الاستقرار السياسي واندلاع الحربين الأولى والثانية، لم يكتب النجاح لهذه الفرق لكي تنمو وتترعرع، بل انحصر الاهتمام بضمان لقمة العيش.
ومن جهة ثانية فإن الإرساليات التبشيرية المسيحية التي قدمت إلى فلسطين، قبل الانتداب البريطاني، سعت إلى فتح المدارس الأهلية والتبشيرية والرهبانيات في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، مثل القدس والرملة ويافا وعكا والناصرة وغيرها. وكانت هذه الإرساليات من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا. وأسهمت هذه المدارس بتقديم العروض والمسرحيات الاجتماعية والدينية في المناسبات المختلفة، الدينية في مواسم الأعياد، والتعليمية في حفلات التخرج، والاجتماعية في النوادي الثقافية. ولعل هذا ما يبرز الدور الديني في تأسيس الحركة المسرحية في العالم، لأن المسرح نشأ في المناسبات الدينية منذ عهد الفراعنة، وبعده اليونان ويليه الرومان، باعتبار الطقوس الدينية تجسد العقائد وتعرض المناسبات الدينية بشكل تمثيلي لتسهيل فهمها.. واليوم نرى القداس في الكنيسة أنه تمثيل وتجسيد لمسيرة ومراحل حياة السيد المسيح. ومن ثم نشأ المسرح من جديد في القرون الوسطى داخل الكنيسة وانطلق منها خارجا. فالمسرح الذي نعرفه ونشهده اليوم في العالم الغربي هو استمرار وتطور للمسرح الديني في القرون الوسطى الذي نشأ في الكنيسة.
وفي فلسطين، ما قبل عام 48 كان لهذه الرهبانيات والمدارس التبشيرية والكنائس الدور الأساس، في إنشاء ورعاية الحركة المسرحية، التي تراوح صعودها وهبوطها مع صعود وهبوط نفوذ هذه المدارس وتأثيرها. لأن المدارس تعتبر إطارًا جيدًا لحضور المسرحيات كما سأورد لاحقًا.
وبالنظر إلى الأعمال المسرحية في المدارس التبشيرية، نرى أنها لم تكن تحرص على مداومة العروض الفنية أو تنميتها، أو صقل مواهب الفنانين، بل كان العمل ارتجاليًا، ويعتبر هواية يمكن ممارستها إلى حد معين لا أكثر، بحيث ينحصر العمل الفني على الإطار المدرسي فقط، وبانتهاء المرحلة المدرسية ينتهي العمل الفني، إلى المناسبة التالية.
ويورد كتاب “دراسات في المسرح والسينما عند العرب” ليعقوب لنداو، وأكد عليها البروفيسور شموئيل موريه، والكاتب عفيف شليوط، في كتبهم، والشهادات التي استمعتُ إليها من كبار السن، أن عددا من الفرق المسرحية المصرية كانت تعرض مسرحياتها، أثناء مرورها ذهابًا وإيابًا بفلسطين، وكان لهذا أثر كبير في تنمية وتعزيز، وبث الروح الفنية والمسرحية في نفوس الجمهور الفلسطيني المتعطش لمثل هذه الأعمال، ومن الفرق المصرية التي عرضت في فلسطين بين السنوات 1925-1932 فرقة “جورج أبيض” التي قدّمت مسرحيات “لويس الحادي عشر” لشكسبير و”أوديب” لسوفوكليس و”الشيخ متلوف” التي ترجمها عثمان جلال عن مسرحية “طرطوف” لموليير. هي مسرحية عن فساد أحد الكهنة، ولكنهم حولوها إلى الشيخ متلوف.. وكذلك فرقة “رمسيس” ليوسف وهبي التي مرت بفلسطين عام 1933 وقدمت مسرحيات متنوعة مثل “أولاد الذوات” و”راسبوتين” و”سر الاعتراف”. وكان يظهر مع يوسف وهبي في مسرحياته، الممثلون حسين رياض وروز اليوسف وزينب صدقي وفاطمة رشدي وأمينة رزق وعزيز عيد وغيرُهم. كما عرضت فرقة نجيب الريحاني مسرحياتها في فلسطين، بمشاركة أمين صدقي وبديع خيري وغيرهما. إضافة إلى فرقة علي الكسار التي قدمت عديدًا من المسرحيات الهزلية خاصة في مدينة عكا. امتد هذا النشاط حتى عام 1946. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفرق المصرية كانت تستعين بشبان محليين في فلسطين، لتقديم الأدوار الثانوية، أو المشاركة في العروض المسرحية، من ترتيبات وترويج، أو تبديل أحد الممثلين الثانويين، إذا أصابته وعكة صحية أو أي مكروه.
لكن ظهور الفرق المصرية في فلسطين، لم يسهم بإنشاء فرقة مسرحية فلسطينية مستقلة. لأن الظروف الملائمة لم تتهيأ لإنشاء مثل هذه الفرقة، وذلك لأسباب عديدة بعضها لا يزال قائما إلى اليوم.. واعتمد الجمهور لإشباع رغباته الفنية، وتلبية مطالبه المسرحية، على عروض الفرق المصرية، التي تقدّم له من الكوميديات والتراجيديات والاجتماعيات وغيرها، ما يفي بالغرض الفني. حتى أن كبار الفنانين كعبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وغيرهم قدّموا عروضًا فنية موسيقية أيضًا في صالات العرض ودور السينما الفلسطينية، على امتداد الساحل الفلسطيني، في الرملة ويافا وحيفا وعكا، وفي حيفا شهدت دار للعرض في سينما عين دور في شارع عين دور الحفلات الموسيقية والغنائية، وفي إحدى المرات قدمت أم كلثوم حفلا فنيا في عين دور، فصرخت إحدى السيدات في الحفل نحو أم كثوم وقالت لها أنت كوكب الشرق.. ومن هنا جاء اللقب الذي حملته سيدة الغناء العربي أنها كوكب الشرق.
وبعد حرب 1948 توقف النشاط الفني، وساد انقطاع تام للفنون المسرحية والحفلات الفنية بسبب الحكم العسكري الذي كان مفروضا. جرت بين الحين والآخر، في مطلع سنوات الستين، عروض لبعض الأعمال المسرحية في الناصرة، وحيفا وعكا، وعدد من قرى الجليل، مثل معليا والبقيعة وترشيحا والرامة وكفر ياسيف وعبلين وعيلبون وكفر كنا وغيرها. هذا عدا عن النشاط الذي ظهر في المدارس الأهلية في كل من الناصرة وحيفا وعكا. كانت العروض في نطاق المدارس والنوادي الاجتماعية وحركات الشبيبة، وأبرزها النادي الأنطوني وحركة العمل الكاثوليكي في الناصرة، وقدم هذا النادي أعمالا في الناصرة وحيفا ويافا والقدس، من بينها مسرحية: “الآباء والبنون” لميخائيل نعيمة. ولكن وقوع البلاد تحت الحكم العسكري، جعل المسرحيات والنشاط الأدبي والفني عمومًا تحت المراقبة والحصار، إذ لم يسمح الحاكم العسكري بأي نشاط من شأنه أن يتطرّق إلى واقع الحياة، أو الاحتجاج أو الانتقاد، فيحظر هذا النشاط بصورة تعسفية، ولا يتورع عن سجن الفنان والأديب أو فرض الإقامة الجبرية بالأقل.. ولا يزال هذا الحظر ساري المفعول ومعمولا به إلى اليوم.
ولكن بما أن المدارس التي تسير على المنهاج التعليمي الذي فرضته السلطة، فقد حرصت هذه المدارس على تقديم الأعمال الفنية، وخاصة المسرحية، بما يتلاءم ورغبات الحاكم العسكري.. كلنا نذكر كيف كنا نحتفل بعيد الاستقلال في المدارس..
هذا الوضع كان ولا يزال متّبعا في الدول العربية، منذ يعقوب صنوع، الذي أطلق عليه الخديوي إسماعيل لقب “موليير مصر”.. ولما انتقد صنوع الأوضاع في مصر سجنه الخديوي. وكتب في السجن مسرحية “موليير مصر وما يعانيه”.
استمر النشاط المسرحي في المدارس بصورة متقطعة، فقد ظهرت بعض الأعمال المتفرقة، وفي المناسبات والأعياد فقط. وكان يشرف على إعداد وإخراج المسرحيات معلمو اللغة العربية في المدارس نفسها، لأن معظم النصوص كانت مقتبسة عن قصص وروايات أدبية، أو تاريخية أو شعرية، أو مما تبقى من النصوص المسرحية القديمة، التي عرضتها الفرق المصرية أثناء مرورها في فلسطين.
المسارح في الناصرة
تأسست في الناصرة عام 1962 فرقة مسرح في نادي الهستدروت، وذلك لأن مدير النادي كان من الأدباء الفلسطينيين وهو الكاتب إبراهيم شباط. وقدّمت هذه الفرقة عددًا من المسرحيات مثل: “الصفقة” لتوفيق الحكيم، و”محاكمة جان دارك”، و”شمعدانات الأسقف”، و”البؤساء”. ثم توقف نشاط هذه الفرقة في حزيران 1966.
استمر النشاط في الناصرة، حيث تأسس “المسرح الحديث” عام 1965 على يد المخرج أنطوان صالح، وفكتور قمر وغيرهما، وقدّم أعمالاً مسرحية بلغ عددها 12 مسرحية، بين التأليف المحلي والعربي والأجنبي، مثل: “السر الرهيب”، “الأيدي الناعمة”، “مجنون ليلى”، “الورطة”، “البخيل”، “مريض الوهم”. وكان العمل الفني يتم بإرشاد المخرج “أنطوان صالح” ابن الناصرة، وهو أول من درس المسرح من الناصرة، وقد سافر إلى فرنسا لدراسة الإخراج، ثم عاد ليمارسه في المسرح الحديث، وهذا شجع هواة آخرين ليزيدوا من اهتمامهم بالمسرح ويطمحوا لدراسته، أو ليقتدوا بالمخرج ويجرّبوا حظّهم أيضًا في إخراج مسرحيات أخرى، مثل المخرج فيكتور قمر وصبحي داموني وغيرهما. وبقي هذا المسرح حتى سنوات السبعين الأولى، ثم تفرق أعضاؤه كل في مجال آخر. بقي المخرج أنطوان صالح في المسرح الحديث لمدة سنتين فقط، ولكنه انفصل عنه ليؤسس “المسرح الشعبي” في الناصرة عام 1967، وتمكّن هذا المسرح أن يقدم مسرحيتين فقط وهما “الأب” لستريندبرغ، و”خادم لسيدين” لغولدوني. واستقطب هذا المسرح الممثلّين يوسف فرح وأديب جهشان من حيفا، وهما أول عربيين يدرسان التمثيل في المعهد العالي للتمثيل في بيت تسفي في رمات غان. إلا أن كلاً من يوسف فرح وأنطوان صالح وفيكتور قمر انتقلوا للعمل في التلفزيون عندما تأسس في القدس، وانحل هذا المسرح.
المسرح الناهض، والكرمة في حيفا
تأسس المسرح الناهض في حيفا عام 1967 وكان مسرحا مستقلا في نطاق بيت الكرمة أولا، وفي 1971 تحول إلى مسرح محترف، يقدم أعمالا مسرحية كانت العصر الذهبي للمسرح الفلسطيني. تم تقديم العروض في بيت الكرمة، ثم انسحب من هناك لأن وزارة المعارف والثقافة قررت دعمه، وخشي العاملون فيه من أن ذلك قد يعني تبعيته للوزارة، وبقي هذا المسرح يعمل حتى عام 1977 فتوقف بسبب الصعوبات المالية التي واجهها. تمكن المسرح الناهض في هذه المرحلة من استيعاب المهتمين والدارسين للمسرح وقدم مسرحيات مثل: “الزوبعة”، “البيت القديم”، “حلاق بغداد”، “رومولس العظيم”، “وبعدين”، “مهما صار” وغيرها. واعتبر هذا المسرح البداية التي لم تنقطع للحركة المسرحية في الجليل حتى اليوم، بالرغم من تبدل الأعضاء أو الإدارة، وساهم في العمل الفني في هذا المسرح كثير من الفنانين مثل: أديب جهشان ومكرم خوري، وسمير البيم ووديع منصور وحسن شحادة، وفريال خشيبون وحبيب خشيبون ويوسف عبد النور، ومروان عوكل ورفول بولس ورضا عزام وسهيل حداد وآخرون، أنا كنت معهم. نادي حيفا الثقافي سيكرم المسرح الناهض، في أمسية خاصة ستقام في 28.8.2025. وظهر بعد الناهض “المسرح الحر” في حيفا وقدم هذا المسرح عملاً واحدًا فقط، مسرحية “زغرودة الأرض” للكاتب سهيل أبو نوّارة من الناصرة وأخرجها أنطوان صالح، وقام بالدور الرئيسي يوسف فرح.
ظهرت في حيفا فرق مسرحية أخرى في نطاق مدرسي، كما حدث في مدرسة “الراهبات الكرمليات” ومدرسة “راهبات الناصرة”، ولكن المسرح الذي لا يزال يعمل باستمرار منذ “الناهض” هو مسرح “الكرمة” التابع لبيت الكرمة، وأصبح هذا المسرح يتلقى مساعدات مالية من وزارة الثقافة ويقدم عروضه في المدارس. وعمل المسرح على إعداد مسرحيات تتفق والمنهاج التربوي في المدارس، كما أعدّ مسرحيات للكبار وأهمها مسرحية “رأس المملوك جابر” لسعد الله ونّوس وإخراج فؤاد عوض، وفازت المسرحية بالجائزة الأولى في مهرجان المسرح الآخر في عكا عام 1989، وبعد ذلك في عام 1997 فازت مسرحية “ليالي الحصاد” بالجائزة الأولى مناصفة مع مسرحية “حلم عربي” التي قدمها المركز المسرحي في عكا.
عمل في مسرح الكرمة عدد من الفنانين وتولى بعضهم إدارته، وأشير إلى بعض الأسماء وليس كلهم مثل سليم ضو، خشية أن أنسى أحدا.
مسارح أخرى
تأسست مسارح أخرى في شفاعمرو حيث ظهر المسرح الثائر عام 1974، ومسرح أبناء شفاعمرو في 1976، والمسرح الشعبي عام 1976، ومسرح آذار عام 1977، ومسرح بيت الشبيبة عام 1977، والمسرح البلدي عام 1981، والمسرح الحديث عام 1994، ومسرح الغربال عام 1977، ومسرح الأفق عام 1996، ولا يزال عاملاً، ومسرح العندليب عام 1999، وقد توقف عن العمل لوفاة مؤسسه مروان عوكل. وفي كفر ياسيف ظهرت حركة مسرحية ضمن جمعيات الناشئة أو شباب كفر ياسيف، وحين تأسس المركز الثقافي عام 1972 بدأ مديره رفول بولس بإخراج عدد من المسرحيات المحلية، وهو نفسه ظهر في المسرح الناهض. وفي قرية البعنة تأسس هناك أول مسرح نسائي عربي في الجليل، حيث عملت قمر خوري نشاشيبي على تأسيسه مع بعض فتيات القرية، وقدم “محبة الوطن” عام 1949. وفي البقيعة أيضًا عرضت مسرحيات منذ عام 1945، ولكن في عام 1977 تأسس المسرح الشعبي، وبعده مسرح الشروق في عام 1989. وفي سخنين ظهر مسرح الجوال عام 1972، وهو لا يزال عاملاً، وكذلك المسرح الأهلي والمسرح الشعبي. وفي طمرة ظهر مسرح في إطار المركز الجماهيري منذ عام 1971 وعمل على فترات متقطعة حتى 2003. وفي عبلين عرضت مسرحيات في أطر الكنيسة والنوادي المختلفة. ومسرح آخر في كفر مندا، وفي المغار، أشرف راضي شحادة على تأسيس مسرح السيرة عام 1984، وكان قد حصل معي على اللقب الأول الجامعي في المسرح، وقدم مسرحيات متنوعة معظمها للأطفال ولا يزال هذا المسرح قائما. ومسرح “الصم والبكم” بإشراف عدنان طرابشة، وهو مسرح فريد بنوعه، إذ يقوم الصم والبكم أنفسهم بأداء أدوارهم المسرحية في قوالب حركية مختلفة. وظهرت مسارح مؤقتة في مجد الكروم، فسوطة، يركا، حرفيش، بيت جن وغيرها.
إلى جانب كل هذا ظهرت أعمال مسرحية ومهرجانات في أطر متنوعة مثل مسرحيات الممثل الوحيد “مسرحيد” وعرضت في هذا السياق مسرحيات مثل: “المتشائل”، “أم الروبابيكا”، “المعطف”، “العكش”، “الزاروب”، “اعترافات عاهر سياسي” ومسرحيات غنائية مثل: “أذكر”، “حوض النعنع”، “كروم الدوالي”، “البيت” و”قطر الندى”. وفرقة سلمى التي دمجت الأعمال الموسيقية والرقص مع التمثيل، لا تزال تقدم عروضها الرائعة.
المسارح المدرسية
الغالبية العظمى من المسارح الآنفة الذكر ظهرت وقدمت أعمالها المسرحية أمام طلاب المدارس، فيقوم مسوقو المسرحيات بعرض برامجهم على مدراء المدارس وهؤلاء ينتقون ما يحلو لهم للعرض أمام الطلاب. وأصبحت هذه ظاهرة ذات وجهين: أولاً، أن الإطار المدرسي يُلزم الطلاب مشاهدة المسرحيات، حتى وإن لم تكن بأفضل مستوى فني، ولكن المسارح حرصت على تقديم مواضيع تربوية واردة في المنهاج الدراسي، كمكافحة المخدرات والحذر على الطرق ومكافحة العنف وغيرها، وفي كثير من الحالات لم تحرص على الإخراج اللائق، وأصبح المجال مشاعًا لمن يشاء بتقديم ما يحلو له. ثانيًا، توخى مدراء المدارس تربية نشئ جديد على محبة المسرح وتعريفه على أهميته، ولكنهم تعاملوا مع المسارح على أساس تجاري لا فني، فأي مسرحية تكلف تكلفة باهظة لا يقبلونها، ولعل المسرحيات زهيدة التكاليف تكون زهيدة فنيًا أيضًا. وكثير من هذه المسارح لم يكتب له النجاح وانسحب من المجال.
محاولة مسرح الميدان
حالفني الحظ أن أكون ضمن مجموعة تأسيسية لمسرح الميدان، وإطلاقه كجمعية مستقلة عام 1995 في حيفا، واهتمت البلدية بتقديم الدعم اللازم له، إلى جانب وزارة الثقافة، ليتمكن من الاستقلالية في العمل بشكل حر تمامًا. واتخذ المسرح مدينة حيفا مقرًا له وفتح فرعًا آخر في الناصرة ثم أقفل، ودأب المسرح على أن يصبح هو المسرح العربي القطري في البلاد، حيث يقدم مسرحيات تلبّي أذواق كافة فئات الجمهور، ويحرص على استيعاب خريجي المعاهد المسرحية العليا في صفوفه، وتأهيل تقنيين للعمل المسرحي. وقدّم المسرح مجموعة من الأعمال مثل: “الملك هو الملك”، “إكسدنت موت فوضوي”، “عبير”، “إضراب مفتوح”، “جزيرة المعز”، “أذكر”، “بيت السيدة”، “زغرودة الأرض”، “سحماتا”، “رقصتي مع أبي”، “مشهد من الجسر”، “بؤس ورعب الرايخ الثالث”، “أحلام شقية” و”حلاق بغداد” وغيرها. إلى أن صدرت الأوامر والقرارات الحكومية بإغلاق مسرح الميدان، الذي تحول اليوم إلى قاعة مسرح سرد. كما ظهر في حيفا مسرح المجد، ليستقر في قلب وادي النسناس، لكن أعماله اتسعت إلى أبعد من الوادي ومن حيفا. ولا ننسى مسرح جبينة، الذي أقامه المرحوم سمير خوري وعمل في النطاق المدرسي في أنحاء البلاد. أعذروني إن نسيت أو فاتني ذكر بعض المسارح، أو الإخوان الممثلين..
تحدثت عن المسارح وليس الأشخاص، لأني سأشعر ببعض الإحراج إن ذكرت فنانا ولم أذكر غيره.. وكي لا أنسى أحدا امتنعت عن ذكر كثير من الأسماء.. ربما يجب أن أذكر صديقي سليم ضو وإدارته لمسرح الكرمة ومسرح الميدان، وكذلك مكرم خوري وفؤاد عوض ويوسف أبو وردة، الذين تعاقبوا على إدارة الميدان.. لن أذكر الجميع. في يافا اليوم تدير روضة سليمان مسرح يافا، ونورمان عيسى مسرح المينا.. وخالد أبو علي مسرح عكا، وكان قبله مازن غطاس في مسرح اللاز. ورياض مصاروة الذي أدار مسرح المركز الثقافي في الناصرة.. ظاهرة مسرح الأطفال فوزي موزي وتوتي، سميتهم ظاهرة لأن هذا المسرح لا زال يحقق نجاحات على مستوى العالم، لا سيما العالم العربي.. وآخرون كثيرون كلهم في موضع محبة واحترام وتقدير.. عندنا نخبة من الفنانين والعاملين في المسرح والسينما، أسماء عالمية، يستطيعون إقامة وإدارة أكبر وأنجح وأهم المسارح، لو أن الإمكانيات المادية والظروف السياسية متاحة لرأينا الوضع مختلفا تماما.
الأدبيات المسرحية
عمل الأدباء الفلسطينيون على إصدار مسرحياتهم ضمن مؤلفات أدبية، دون أن تكون معدّة للتمثيل، ونلاحظ أن الأدباء كتبوا مسرحياتهم دون أن يمرّوا بتجربة التمثيل أو الدراسة المسرحية، إلا قلّة منهم، أسماء قليلة جدا مثل: الدكتور محمود عباسي، سليم خوري، الدكتور سليم مخولي، نايف خوري، فاطمة ذياب، عفيف شليوط وكرم شقور وآخرين. المسرحيات التي وضعتُها شخصيا، اعتمدت فيها على ذكاء المخرج والممثلين، لكي يبدعوا في عملهم في الإخراج والتمثيل، وما أعطيت ملاحظات أو تعليمات إخراجية أو تمثيلية.. ولذا اعتبرت معظم المسرحيات أعمالا أدبية أكثر منها فنية. ونجد أيضًا أن نصيب المسرحيات المحلية كنصيب الرواية والقصيدة والقصة، بحيث لم يعتمد المسرحيون عليها تمام الاعتماد، بل استعانوا بالمسرحيات العربية الأخرى أو العالمية والأجنبية، لعلها تنال إعجاب الجمهور. وفي اعتقادي أن المسرحيات المحلية يمكنها أن تفي بالغرض إذا أجري لها الإعداد اللازم. وبإلقاء نظرة على المسرحيات العربية المحلية نرى أنها متنوعة المواضيع ومتعددة الأساليب، أي بين مسرحيات جماعية أو للممثل الواحد.
وعلى صعيد النقد الفني والمسرحي فإن المؤلفات الأدبية بهذا المجال قليلة إذ لم يتعرّض النقاد للأعمال المسرحية من وجهة نظر فنية، بل من النظرة الأدبية، وفي هذا إجحاف للعمل الفني، فقد وضع الدكتور حبيب بولس كتابه “لعبة الإيهام والواقع” مستعرضًا بعض الأعمال المسرحية كبحث أدبي اجتماعي. وكتب راضي شحادة “هواجس مسرحية” وهي دراسات وتنظيرات للمسرح الفلسطيني. وكتب نبيل عودة “الانطلاقة” كمقالات أدبية لأعمال أدبية ومسرحية. وكتب نايف خوري “على مسرح الحياة” مقالات استعراضية لأبرز الأعمال المسرحية بين الأعوام 1970-2000. ووضع عفيف شليوط كتابه جذور الحركة المسرحية..
الناقد الفني، مثله مثل الناقد الأدبي في مجتمعنا، عدا عن عدم إلمامه بالنواحي الفني واختصاصه بالمسرح أو السينما أو الفنون الأخرى، فإنه في موقف لا يحسد عليه، فسيقسم الفنانين، مثل الكتاب والأدباء إلى قسمين، من يرضى عنه لأنه يمدحه، ومن يعاديه لأنه كتب نقدا ضده.. لكن هذا النقد الفني غير موجود أصلا في أدبنا المحلي.
المسرح البلدي في الرامة
اخترت الختام لحديثي اليوم عن المسرح في الرامة، لأني سأتحدث عن عملي الشخصي في المسرح، ولماذا أقف أمامكم هنا.. أنا من مواليد قرية الرامة في الجليل، عام 1950، لعائلة مهجرة من قرية إقرث، تعرفونها على الحدود اللبنانية، ومنذ طفولتي، بالصف الأول، كنت أشاهد المسرحيات التي تقدمها فرقة المدرسة في الرامة ويشرف على إخراجها معلم اللغة العربية آنذاك في حفل تخريج الصف الثامن الابتدائي، سيذكر المتقدمون سنًا ذلك في قراهم ومدارسهم. في كل عام كان الاهتمام منصبًا على أي مسرحية ستقدم في هذا الاحتفال، وأي نص مسرحي سيتم اختياره. ويحضر هذه الاحتفالات أولياء الأمور ووجهاء البلدة وشخصيات من القرى المجاورة لمشاهدة العرض المسرحي. إلى أن حان موعد تخرّجي في عام 1964، وكما أذكر، أننا قدمنا مسرحية للكاتب سليم خوري بعنوان “وريث الجزار”، ولاقت نجاحًا، الأمر الذي حدا بالخريجين في فوجنا، أن نقرر تأسيس مسرح ثابت في الرامة، لتدوم العروض فيه بصورة متواصلة. وبما أني كنت من المؤسسين، فقد أطلقنا على المسرح اسم “المسرح البلدي” وقدمنا المسرحيات المتنوعة مثل: “شمس النهار”، “الآباء والبنون”، و”الأيدي الناعمة” وغيرها وقام بالإخراج معلمو اللغة لافتقار البلدة إلى مهنيين في المسرح. وانطلقت العروض في عدد من القرى حيث عرضت “الآباء والبنون” في فسوطة وعبلين وكفر ياسيف. وبعد تخرجنا من المرحلة الثانوية قررت أن أدرس المسرح في الجامعة، ووضعت نصب عيني هذا الهدف لتحقيقه، ولكن ضيق ذات الحال جعلني أتجه الى دار المعلمين في حيفا، فالتحقتُ بها لمدة سنة في عام 1968، وفي حيفا تأسس من قبل المسرح الناهض كما ذكرت. وشاركت بتمثيل مسرحية “رومولس العظيم” مع “الناهض” كما شاركت بالتمثيل في مسرحية “مجنون ليلى” في دار المعلمين. ولكني عزمت على دراسة المسرح بتخصص، ويكون بذلك تلبية لرغبتي وهوايتي، وكذلك أستطيع احتراف العمل المسرحي كدارس ومختص في الموضوع. فالتحقت بجامعة القدس، وكنت أول عربي يحمل اللقب الأول، البكالوريوس، من هذه الجامعة بتخصص واسع في مجال المسرح واللغة العربية. وكان زميلي في الدراسة أيضا الكاتب والمخرج راضي شحادة. وقد تخرّجنا في عام 1974. رجعت إلى الرامة لأقوم بإخراج عدد من المسرحيات والأمسيات الفنية في نطاق مركز للأحداث في كنيسة الروم الكاثوليك، وأخرجت مسرحيات مثل: “ورقة يانصيب” و”عروس الجليل” وسواهما. إلا أن ظروف العمل كانت شاقة وبغير راتب فانتقلت إلى حيفا عام 1975، وعملت في مجالات أخرى، وعكفت على الكتابة المسرحية والنقد الفني، وصدر لي عدد من المؤلفات التي لم تجعلني أتقاضى منها أي راتب..
الخلاصة
باستعراضنا لهذه الحركة المسرحية الفلسطينية نجد أن الأعمال الفنية تفاعلت تفاعلاً حيًا مع الجمهور، حيث ظهر منها الغث والسمين وفقًا لمتطلبات الجمهور والمواضيع التي عالجتها هذا الأعمال. وتبقى المعادلة مثيرة للحيرة والتي تظهر في كل العالم وهي: هل تُقدم المسارح ما يريده الجمهور أم أن الجمهور يقبل المسرحيات التي يعدّها الفنانون لأجله؟
كما يبقى التساؤل مطروحًا حول جودة العمل والميزان الذي نقيس به هذه الجودة، ليصبح لدينا مسرحًا مرموقا.
ومع كل هذا التاريخ الفني منذ مطلع القرن العشرين وحتى اليوم، نرى أن المسرحيات والمسارح التي عملت في الساحة الفلسطينية، كانت مجرد محاولات لظهور حركة مسرحية ثابتة ودائمة العمل والحضور، ولم تفلح كل هذه الجهود بالرد على السؤال: هل أصبح لدينا مسرح فلسطيني؟
وهنا أعتقد أن المقولة: “المسرح يرافق الحضارة” يمكنها أن ترد على هذا القول إذا اعتبرنا أن أعمالنا الأدبية والفنية والاجتماعية والفكرية تنصبّ في الإطار الحضاري الواسع. وقد تثبت هذه المقولة بأننا لا نزال في الطريق نحو الهدف الذي لم يتحقق بعد!!
ولا بد من الإشارة هنا إلى بعض الأسباب التي حالت دون وجود مسرح فاعل ومتفاعل، ينتمي إليه الجمهور، ويشاهد مسرحياته يوميا. ومن هذه الأسباب الصراع القائم والحاد بين السلطة التي تحاول طمس حضارتنا كفلسطينيين، من خلال عدم الاعتراف بفلسطين والفلسطينيين.. وهذا الصراع الذي لا يزال في أوجه، حاولت السلطة سد كل المنافذ، وأهمها الدعم المادي والحرمان المالي، كما فعلت السلطة في مسرح الميدان وغيره.. وكذلك، لم يجد الممثلون، وغيرُ الممثلين السبل التي يمكنهم العيش فيها من خلال العمل المسرحي العربي!! وغالبيتهم، إن لم أقل كلهم، عملوا وظهروا وحققوا نجاحات وبرزوا عن سواهم في المسرح العبري، لكي يستطيعوا أن يأكلوا لقمة العيش من عملهم هناك.. حتى أصبح الفنانون يتضايقون من توجيه كلمات اللوم إليهم بالسؤال: لماذا يجب على الممثل العربي، لكي ينجح ويعمل، أن يمر عن طريق، أو يلجأ إلى المسرح العبري.. وكأن المسرح العبري هو بوابتنا للمسرح العربي.
وأنا على يقين بأنه لو توفر مسرح عربي في بلادنا، كما هو الحال في بلاد الرقي المسرحي، لوجدنا مبدعينا الممثلين والمخرجين يعملون فيه ويجعلونه خالدا أبدًا..
-
نشر هذه المحاضرة في مجلة الآداب في بيروت – لبنان عام 2003
والآن تم إعدادها في نطاق رابطة خريجي الكلية الأرثوذكسية العربية – حيفا
تعبّر هذه المواضيع المنشورة عن آراء كتّابها، وليس بالضّرورة عن رأي الموقع أو أي طرف آخر يرتبط به.

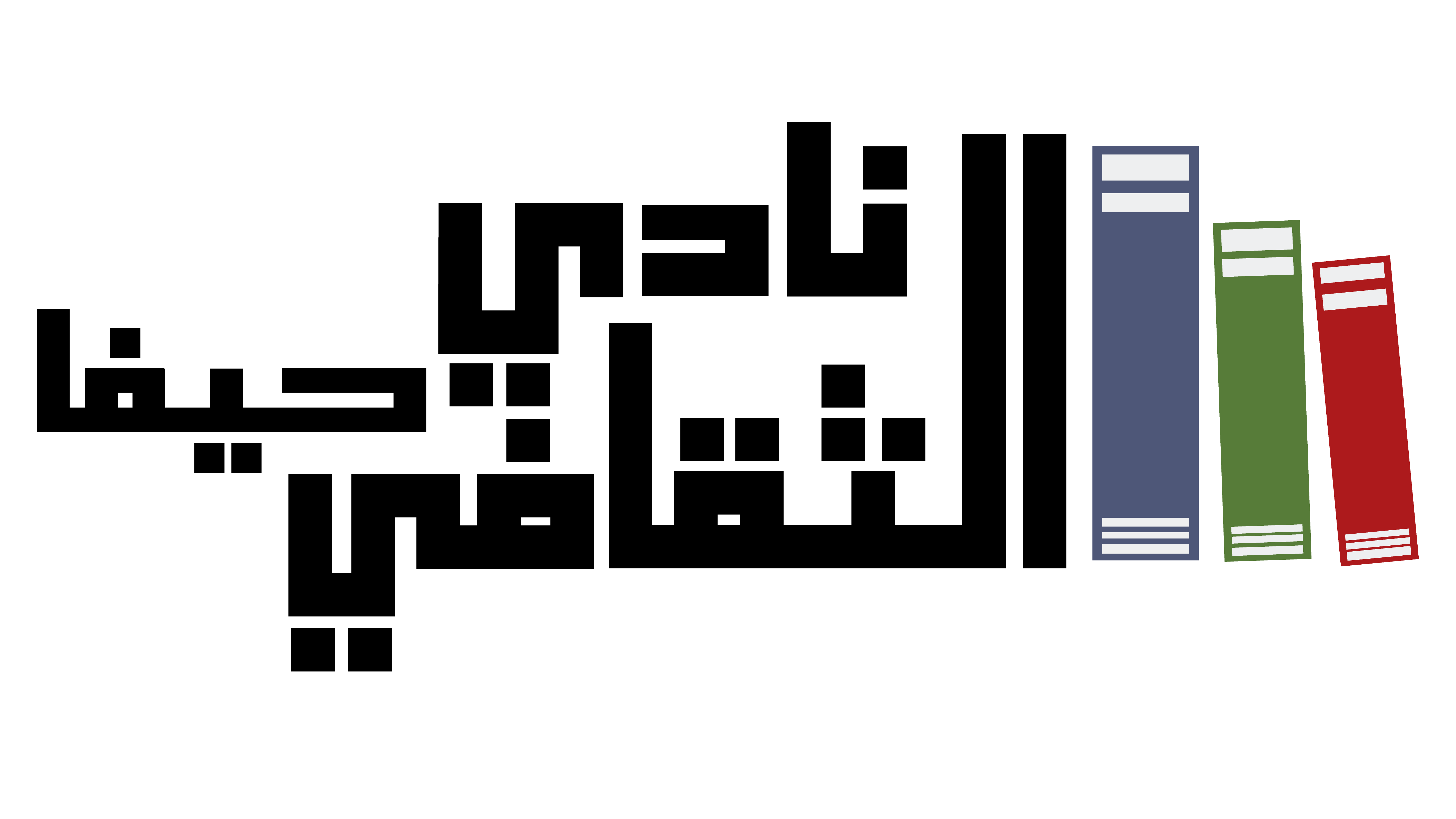 haifacultureclub
haifacultureclub

