د. نسيم الأسديّ: ملامح الرّواية الحداثيّة في رواية “سادن المحرقة” للأديب باسم خندقجي

د. نسيم عاطف الأسديّ
أستهلّ مداخلتي باعتراف مفاده أنّي ورغم قراءتي للعديد من الرّوايات أميل أكثر للقصّة القصيرة، حيث الأمور تبدأ وتنتهي سريعًا، وتكون الوجبة الفكريّة والشّعوريّة مركّزة أكثر، ولكنّ هذا الاعتراف يقودني حتمًا إلى اعتراف آخر وهو أنّ هذه الرّواية من أفضل الرّوايات الّتي قرأتها، لا لأحداثها فحسب، بل لذلك الأسلوب القويّ المميّز والجذّاب الّذي استمالني بكلّيّتي لأنهي قراءتها في بعض جلسات التهمت فيها الصّفحات بنهم العاشق المشتاق. أسلوب مزج بين السّياسة والرّواية الحداثيّة الّتي سأخصّص مداخلتي اليوم عنها، لأبيّن مزاياها من خلال روايتنا سادن المحرقة، واسمحوا لي مسبقًا أن أقدّم تحيّةً وإجلالًا لكاتب الرّواية باسم خندقجي على ما أبدعه هنا من عمل أدبيٍّ مميّزٍ وراقٍ.
هذه الرّواية كما أسلفت هي رواية سياسيّة حداثيّة، والرّواية الحداثيّة جاءت كردٍّ على المدرسة الواقعيّة، والّتي بدورها جاءت كردٍّ على الرّواية الرومانسيّة الّتي ابتعدت عن الواقع. الرّواية الحداثيّة تركّز على بطل واحدٍ، غنائيّة في أسلوبها أي تميل للتّعبير عن الحالات الوجدانيّة والانفعالات والعواطف، رمزيّة في توجّهها، توظّف الحوار الدّاخليّ وتيّار الوعي (حيث الكلام غير منظّم. الضّمائر تتكلّم عن نفسها بضمائر مختلفة)، وتوظّف الأحلام والاسترجاعات، إضافةً إلى تقنيّات ووسائل حداثيّة أخرى. نلاحظ في الرّواية الحداثيّة المزج السّياسيّ بالنّفسيّ، بالميتافيزيقيّ، والصّوفيّ.
العالم الخارجيّ في الرّواية الحداثيّة فقد صلابته، ولكي يعبّر الرّواة عن عالمهم الدّاخليّ هجروا التّقنيات التّقليديّة (مثل الحبكة مُحكمة البناء، والأحداث المرتّبة وَفق التّرتيب الزّمنيّ والمرتبطة بالرّاوي العليم)، لمصلحة شكل غير مقرّر، والبداية والوسط والنّهاية غيرُ واضحة، وهناك طمس للحدود بين الواقع والحلم، واللّجوء إلى الاسترجاعات بأنواعها، وتوظيف لغة شاعريّة تعتمد على التّصوير والتّلميح لا على التّقرير، واستعمال الأساطير والتّراث الشّعبيّ والتّراث الأدبيّ العربيّ.
تحتاج رواية سادن المحرقة إلى قارئ ماهر حاذق ليعرف كيف يرتّب الأحداث ترتيبًا زمنيًّا صحيحًا يساعده على فهم الأحداث وعلاقتها المنطقيّة ببعضها، ذلك لأنّ الحبكة فيها بعيدة في ترتيبها عن الحكاية، والحكاية هي أبسط وأدنى التّراكيب الأدبيّة، وهي تتابع الأحداث المرويّة زمنيًّا، كما لو كانت تحدث في الحياة الحقيقيّة، أمّا الحبكة فهي سلسلة من الأحداث يقع التّأكيد فيها على الأسباب والنّتائج. ونلحظ وبشكل واضح الخلط بين واقع الرّاوي (أور شابيرا) في الرّواية مع أحلامٍ أو ذكريات أو أوهامٍ أو ماضٍ، أو مزج الحقيقة بالخيال . ومثال ذلك في روايتنا حوار الرّاوي مع طبيبته (هداس) حين تقول له: “أن تكتبَ عن نفسِكَ بضمير الغائب، يعني أن تخلقَ مسافةً بينك وبين الواقع من جهة، وبينك وبين الخيال من جهة أخرى.” ويردُّ هو قائلا: “هل تقصدين أنّني لم أعد أميّز الخيال من الحقيقة”.
ولا يفارق الرّاويَ الضّياعُ والمزجُ بين الواقع والخيال مرّة تحت سيطرة البوست تراوما، ومرّة برعاية سيجارة الميرجوانا، ومرّة، ومرّة، ومرّة.. ومثال ذلك حواره مع صورة الطفلة المنعكسة في المرآة ص 154 لينتهي به الأمر بكسر المرآة برأسه بعد أن تحدّاه انعكاس الطّفلة أن يفعل ذلك. ومن أمثلة هذا الخلط أيضًا حوارات الرّاوي مع نور الشّهدي مُنتحلُ شخصيّته، فهذا الحوار كان يجري خلال استماعه إلى (بودكاستات) نور الشّهدي، وتداخل رسائل مريم على الواتس أب. ويصل الضّياع قمّته حين يسألُ أور شابيرا مُنتحلَه نور الشّهدي: “ألم تشعر بفداحة التّناقض يا رجل؟! ألم يحرقْكَ قلبُكَ الفلسطينيّ أثناء ارتدائك لقناع يهوديّ أشكنازيّ صهيونيّ؟! لو كنت مكانك لاحترقتُ وجننتُ ووقعتُ مهشّمًا في هاوية الالتباس”. ثمّ نجد الرّاوي يخاطب نفسه في المرآة ليقول: “صباح الخير… أنا نور… نور الشّهدي”. لا، بل سأقول: “عمتم صباحًا. أنا يورغن… يورغن فروم”.
وممّا يزيد هذا الخلط والضّياع أنّ نور الشّهدي كان يبحث عن نقاط تعيين في بودكاستاته ليفهم الحالة الّتي يعيشها، تمامًا كما كان يبحث أور شابيرا عن نقاط التّعيين ليجد نفسه وينقذها من البوست تراوما.
وهكذا فالرّاوي أور شابيرا اليهوديّ الأشكنازيّ معاق الجيش الإسرائيليّ، يكون مرّة أور شابيرا الّذي يعمل دليلًا سياحيًّا وباحثًا أثريًّا، ومرّة نور الشّهديّ العربيّ المهجّر إلى رام الله من بلدته الأصليّة “اللّد”، ومرّة يورغن فورم الألمانيّ.
الاغتراب في الرّواية:
عدد كبير من الرّوايات الحداثيّة يعبّر عن الاغتراب في جميع المستويات، وعن شعور بالمعاناة السّياسيّة نتيجة للعيش تحت سلطة أنظمة تسلّطيّة وقمعيّة، ومزاجيّة. وهكذا فإنّ أبطال الرّوايات الحداثيّة (التّجريبيّة) يميلون إلى كونهم لا أبطال، فهم غير واثقين من أنفسهم، وعاجزون، فقدوا إحساسهم بالاتّجاه، يشكّون بأنفسهم، وغير قادرين على السّيطرة على حياتهم ومصيرهم أو مصير بلادهم، لذلك تمّ التّركيز على عالمهم الدّاخليّ، فنجد تحليلًا لمشاعرهم وتوجّهاتهم. مثل هذا الاغتراب نجده في الرّواية عند الرّاوي في اختياره أن يكتب عن نفسه كما طلبت طبيبته النّفسيّة (هداس)، وقد اختار أن يكتب عن نفسه بضمير الغائب لا بضمير المتكلّم، وهذا دليل واضح على حالة الاغتراب والانفصام الّتي يعيشها الرّاوي. ونجد حالة من عدم الوضوح، ومن التّيه في المشاعر والتّخبّط في الاتّجاه المرجُوِّ في شعور الرّاوي تجاه والده المريض الغائب عن الوعي ص 30:”لا أشاء أن أؤذيه الآن بزفراتي الحارّة وذكرياتي وأيّامي برفقته، بل أشاء أن أؤذيه. أريد أن أصرخ بكلّ آلامي في وجهه المطفأ، أن أُعاتبه، أصارحَه، أجرحَهُ، أُداويه، أحبَّه، أكرهَه، أعانقه، أبكي في حضنه”. ونجد الرّاوي يتحدّث عن نفسه بضمير الغائب فيقول ص 47: ” .Show must go onعلى إيقاعها الحماسيّ الهائج رقّص رأسه الملفوف بدخان لفافة الماريجوانا، لم يملّ بعد من الاستمرار في عرض ذاكرته داخل هذا الدّفتر.. [..] أخذته الماريجوانا وأخذته الأغنية إلى الماضي، إلى دوّي المدافع والرّصاص والعويل والدّماء..”.
ويقول ص 50:”بلى، لقد اختلطت الأشياء، اختلطت إلى حدّ الجنون”، ويقول صفحة 73: “أسير على رصيف الشّارع المحاذي للمقبرة العلمانيّة الواقعة في رمات جان، واستمتع بحسن شمس صباحيّة تُدرك أنّ اليوم هو يومٌ مميّز يجمع على مائدته الحنان والقسوة والمحبّة والكراهيّة والحياة والموت والأمومة ويُتم الأمومة والوفاء والخيانة. إنّه عيد الأمّ الرّبيعيّ. اليوم عيد الحياة، وأنا مقبل على المقبرة. اليوم هو الإثنين، وأنا ثاني اثنين لأمٍّ جثمانها موارى في هذه المقبرة منذ عامين. وفي صفحة 74:” أشتاق إليك… لا أشتاق.. أحبّك كأمٍّ وأكرهك كامرأة.. أعبدك، اكفر بك، وألعن تلك اللّحظة الّتي تسبّبت بتحطّمي في ذلك المكان الخاطئ، في ذلك النّهار الأسود. لا، لا يا أمّي، يا حجّة ضمير الغائب، ومناجاتي له فوق هذه الصّفحات”.
المعلومات حول الشّخصيّة:
المعلومات حول الشّخصيّة في الرّواية الحداثيّة تتدرّج خلال الرّواية لترسم ملامح الشّخصيّة بصورة كاملة مع نهاية الرّواية، ويُطلق على ذلك “التّرذيذ” (تأتي المعلومات كالرّذاذ رويدًا رويدًا). ويبدو هذا جليًّا واضحا في روايتنا، إذ إنّنا لا نتعرّف على الشّخصيّات في الصّفحات الأولى من خلال كُتَلٍ نصّيّة تصف لنا الشّخصيّة خارجيًّا وداخليًّا كما في الرواية الواقعيّة، بل نتعرّف على الشّخصيّات أكثر كلّما قلّبنا صفحات الرّواية لترتسم الصّورة النّهائيّة مع انتهاء الرّواية، فمثلًا ص 25 ومن خلال عدّة استرجاعات تعطينا بعض التّفاصيل عن الّراوي:
-
زيارتك لمخيّم الإبادة النّازيّ في أوشفيتز في بولندا، خلال دراستكِ في المرحلة الثّانويّة.
-
موت كلبتك سامو دهسًا، وتجنّبك اقتناء كلبة جديدة.
-
مشاجرات أبيك وأمّك.
-
فشلك في ممارسة المحاماة، بعد تخرّجك من كلّيّة الحقوق في جامعة تل أبيب. وغير ذلك.
نحن نعرف اسم الرّاوي في روايتنا في صفحة 46، حين يطلب من مدرّس الخطّ العربيّ أن يكتب اسمه بالعربيّة لنكتشف أنّ اسمه أور شابيرا، وقبل ذلك عرفنا على امتداد الصّفحات أنّه يهوديّ يسكن تل أبيب بعد أن جاء من مجدال مع والديه، وعرفنا أنّ أخاه قد مات أثناء خدمته في الجيش وأنّ والده مريضٌ، وأمّه متوفّاةٌ، وأنّه يحلم بالعربيّة؛ ما دفعه على تعلّم هذه اللّغة عن طريق المعلّمة العربيّة مريم فاطم. وصفحة 73 نعرف أنّ أمّه كانت طبيبة. وفي صفحة 75 نعرف أنّ أمّه كانت تخونُ والدَه مع زميلها الطّبيب (مودي) شريكها في العيادة. وهكذا فإنّ طريقة تزويد المعلومات حول الشّخصيّات لا تكون من خلال كُتلٍ نصّيّة في بداية الرّواية، أو لحظة دخول الشّخصيّة الأحداث، بل من خلال عمليّة التّرذيذ.
الجانب الفلسفيّ في الرّواية:
يلحظ القارئ على امتداد الرّواية تلك الجمل الفلسفيّة الموزّعة بين سطورها، والّتي تحتاج هي الأخرى إلى قارئ مثقّف حاذق يفهمها ويربطها مع أحداث الرّواية ليفهم ما جرى أو يتنبّأ بما سيجري من أحداث. ومن أمثلة ذلك قول الرّاوي ص 12:”ضمير الغائب؟ أهو طوق نجاةٍ من هاوية الواقع، أم انتحار في هاوية الماضي؟” وقوله في نفس الصّفحة: “إنّ الكتابة بضمير الغائب هي الأمل بعودة ضميرٍ غائب”. ويظهر الجانب الفلسفيّ كذلك فيما جاء على لسان الرّاوي ص 14: “أنتقل بحذر كما لو أنّني أنتقل فوق جثامين أحبّتي” وهذا القول يذكّرنا بشاعر الفلسفة العربيّ الأوّل أبي العلاء المعرّي حين قال:
خفِّفِ الوطءَ ما أظنُّ أديمَ الـ أرضِ إلاّ من هذهِ الأجسادِ
سِرْ إِنِ اسْطَعْتَ فِي الْهَوَاءِ رُوَيْدًا لَا اخْتِيَالًا عَلَى رُفَاتِ الْعِبَادِ
وكذلك قوله صفحة 86:” قلت يوما لهداس إنّني لا أؤمن برواية الحقيقة، وإنّما بحقيقة الرّواية”.
وصفحة 131 يقول: “لحظة واحدة. لماذا لا يكون القعر هو الوجه الآخر للسّطح؟ لماذا لا يكون الواقع مصابًا بانفصام الشّخصيّة، تارةً سطحٌ وتارة أخرى قعر؟”.
ومن الفلسفة أيضًا ما يذكره نور الشّهدي في بودكاسته حول المركز والهامش ص 194، وتلك الاقتباسات من كتابه الجديد “سيرة لكائنات كولونياليّة” ص 196.
ومن الجمل الفلسفيّة أيضًا ما ورد ص 199 في الحوار المقتبس من كتاب نور الشّهدي مع طفل الحجارة، يقول:
-
لا تخفْ.
-
لماذا؟
-
لأنّكَ النّور.
-
وهل قَدَر النّورِ الظّلام؟”
وهكذا أكون قد وقفت معكم على أهمّ ملامح الرّواية الحداثيّة من خلال رواية سادن المحرقة للكاتب باسم خندقجي.
واسمحوا لي أن أختتم بهذه الأبيات التّي نظمتها تكريمًا للكاتب باسم خندقجي:
في خندقٍ بينَ السّياسةِ والأدبْ
ما كان خندقجيُّ يشعرُ بالتّعبْ
صاغ الـــرّوايَــــةَ مُــبدعًا فــي نثــــرهِ
فإذا الحروفُ تَنُمّ ألوانَ العَجَبْ
وكــــأنّــما الإبـــداعُ أزهــرَ حَــــولَـــــهُ
فاختارَ أجوَدَهُ مَقـــامًـــا وانـــتَخبْ
لو أنّ حِبرَ الــنّصِّ كــــانَ بِــــقَـــدرِهِ
لرأيتَ نَـــصّكَ خَطَّهُ ماءُ الذَّهبْ
تعبّر هذه المواضيع المنشورة عن آراء كتّابها، وليس بالضّرورة عن رأي الموقع أو أي طرف آخر يرتبط به.

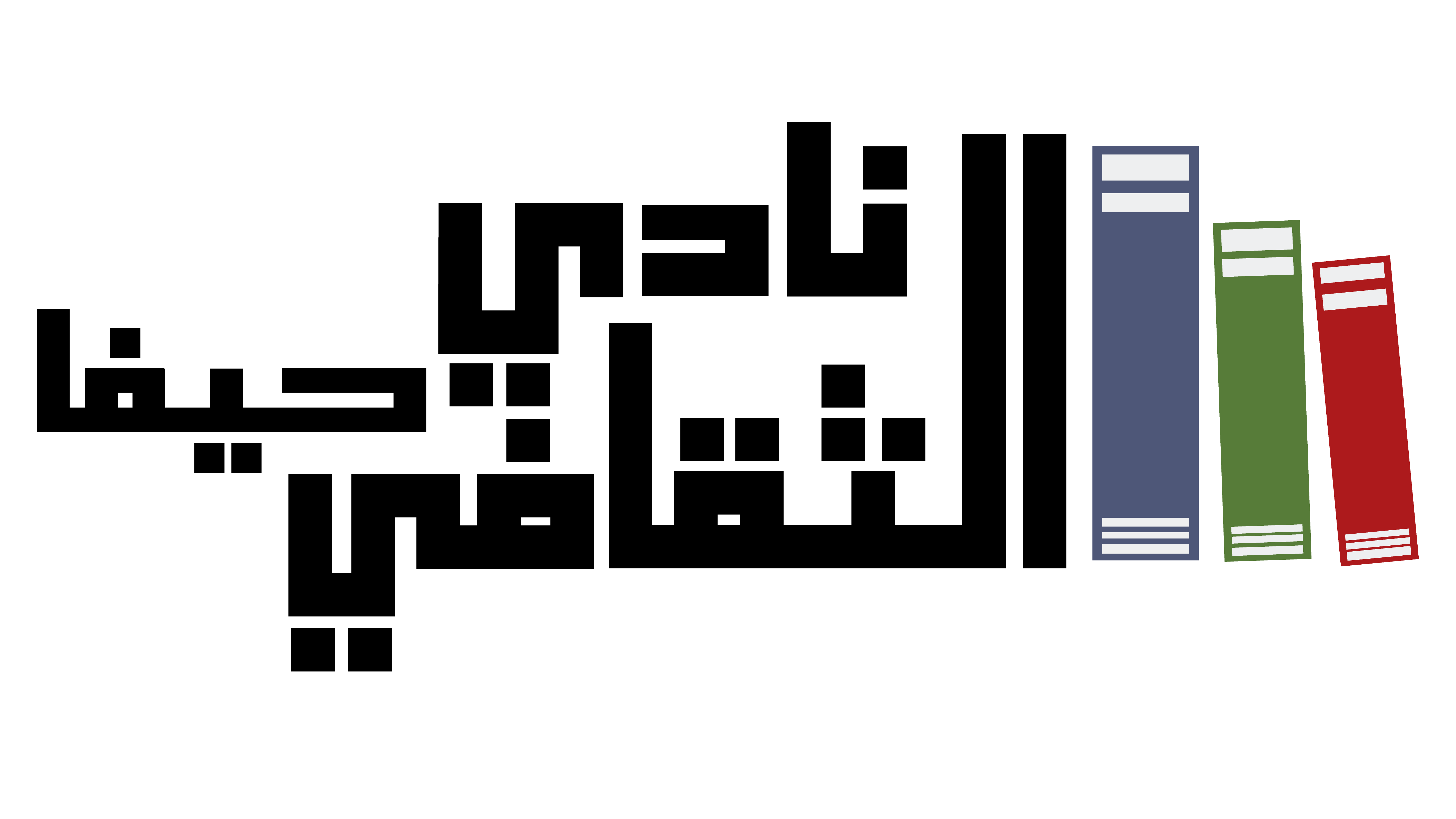 haifacultureclub
haifacultureclub

