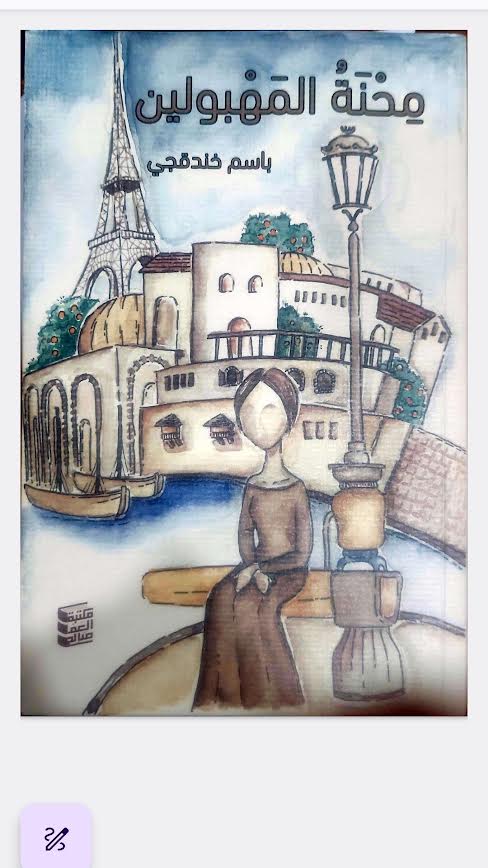د خالد تركي: نافِذَتي تُطِلُّ على رِوايَة “مِحْنَةُ المَهْبولين”

د خالد تركي
كان لقائي الأَوَّل مع الكاتب الأَسير باسم خندقجي عام أَلفين وتسعةٍ حين أَرسل تعازيَه، من وراء قضبان السِّجن، لعائلتي بوفاة المناضل داود تركي، أَبو عائدة، حيث جاء في تعزيته “صمدتَ في وجه الأَنواء والعواصف، قاومتَ وعاركتَ الظُّلم والظَّالمين، وخرجتَ من غياهب السُّجون مرفوعَ الرَّأسِ والجبينِ، وخضتَ الكثير من الإِضرابات عن الطَّعام وتحمَّلت العقاب الإِنفراديَّ لقهرك، لكنَّهم لم ينجحوا في ثَنيك عن مبادئك، وعُدتَ إِلى عروس الكرمل دون ندمٍ أَو اعتذارٍ وبقيتَ في حيفا إِلى أَن أَخذ سيِّدُنا وديعته..
باقٍ في حيفا جسدًا وروحًا وحضورًا..
وكان لقائي الثَّاني معه في روايته “نرجِس العُزلة”، حين كتبتُ في كتابي “سفر برلك” (ص 67)، عن الشلُكَّات:
لقد كانوا يقولون، وما زالوا، عن العسس والوُشاة، من عملاء السُّلطة، إِنَّهم اولاد “شْلُكِّي”، أَو إِبن هالشْلُكِّي، والشلُكِّي هي كلمة تركيَّة تعني الزَّانية، ونابلس مشهورة بالحلويَّات الطَّيِّبة والزَّكيَّة وعندهم نوع من أَنواع الحَلوة يُسمَّى “قطايف شلُكَّات” وفي رواية الأَسير باسم خندقجي “نرجس العُزلة” (ص 122) الصَّادر عن “المكتبة الشَّعبيَّة ناشرون” عام أَلفين وسبعة عشر، “كان الأَغراب عن المدينة وضيوفُها وزائروها يُفاجأون حين يسمعون مُضيفيهم يقولون لهم: سندعوكم على شْلكَّات في البلد..
سأُطعِمكم شلُكَّات..
.. ماذا؟
يا عمِّي شلُكَّات يعني حلوى القطايف..
وأَلتقي معه أَيضًا في أَحضان العائلة الأَسيرة، فنحن من عائلة واحدةٍ، الأَسير داود تركي، أَبو عائدة، والأَسير فايز تركي، أَبو مروان، ناهيك عن ابنة عمِّي عائدة الموجودة في الشَّام قسرًا بعد الإِعتقال، والمضايقات التي لاحقت عائلتي جرَّاء هذا الاعتقال، وما بدَّلنا ﴿..تبديلا﴾..
أَنت تختار رفاقك وأَصدقاءك..
رواية “مِحنةُ المَهبولين” هي رواية تخرج إِلى الحرِّيَّة من بين قضبان السِّجن، من “صندوق سجن هداريم الصَّهيونيِّ” (ص 249)، من عرين الأَسد، من زنزانة الأَسير باسم خندقجي، لترى النُّور نيابة عن كاتبها، أَسيرِ الحرِّيَّة، على أَمل أَن يحظى بها في القادم من الأَيَّام..
وها هو يخرج من صندوق هداريم إِلى القاهرة حرًّا طليقًا مرفوع القامة عالي الجبين ليعود عن طريقها إِلى يافا ليجد مريمه، هي الأُخرى حرَّةً طليقةً تنعم بدفءِ ذراعيه على شاطئها وبين بيَّاراتها..
الرَّابع عشر من تشرين الأَوَّل من هذا العام، ذكَّرني بالعشرين من شهر أَيَّار عام أَلفٍ وتسعمائةٍ وخمسةٍ وثمانين يوم تحرَّر أَبو عايدة داود تركي من قفص الرَّملة إِلى حيفا..
الحرِّيَّة لأَسرى الحرِّيَّة..
تدور أَحداث الرِّواية بين يافا ورام الله والبحر ومرسيليا وباريس..
يافا في موسم قطاف البرتقال، يافا “بين أَريج البرتقال ورائحة البحر، إِنَّها هي، تلك التي لا تلتفت إِلا للبحرِ”(ص 13)، ورام الله في موسم جداد الزَّيتون، “البلد الورعة بأَهلها أُولئك الذين يعتنقون الأَرض، فلاحون، على سُنَّة خيراتها وعرق زيتونها ويسوعها..” (ص 64)، ترسو السَّفينة في مرسيليا ويتَّجهون برًّا إِلى باريس..
يافا ورام الله والبحر والأَرض، أَرضُ البرتقال وأَرضُ الزَّيتون هذه الرُّموز تجتمع في مكوِّنٍ واحدٍ اسمه فلسطين..
ويقارن أَنيس، بطل الرِّواية، فترة قطاف البرتقال في يافا وجداد الزَّيتون في رام الله، “فالعمل في قطف البرتقال هيِّن وممتع وكان أَنيس يندمج فيه بكلِّ سرورٍ وهناءٍ ومواويل، لكنَّه لم يكن قطافًا على هذه الرَّوعة الجماعيَّة التي يشهدها الآن..”(ص 78) في جداد الزَّيتون، حيث تجتمع العائلة في قطف جماعيٍّ، من رجال ونساء وأَطفال، يجلسون براحتهم لتناول وجبة الإِفطار الملوكيَّة الغنيَّة بتنوُّعاتها وأَصنافها تحت ظلال أَشجار الزَّيتون، الأَمر الذي يعزِّز الرَّوابط العائليَّة والإِجتماعيَّة والتُّراثيَّة، بينما يشترك الرِّجال فقط في قطف البرتقال فهو “لم يلمح يومًا”(ص 78) اشتراك النِّساء في موسم قطف البرتقال..
حتَّى يكون العمل ناجحًا وناجعًا يجبُ اشراك النِّساء الماجدات به..
“في رام الله يسود البرد وفي يافا يسود الدِّفء أَكثر”(ص 64)..
كانت باريس في زمن ثورتها وانتصار الشَّعب على الطَّاغية الملكيَّة، في القرن التاسع عشر، عام أَلفٍ وثماني مائة وثمانية وأَربعين، سقوط الملك لويس فيليب، و”انتحار المفتِّش جافيير بعد فشله..” (249)، (جافيير هو مفتِّش بطل ثانويٌّ في رواية “البؤساء” لفيكتور هيجو) قُضي على الحكم الملكيِّ الدُّستوريِّ ونجحت الثَّورة في تأسيس النَّظام الجمهوريِّ الدِّيموقراطيِّ، لتكون فاتحةً لكومونة باريس لاحقًا، في الوقت نفسه كانت بلادي، ترزح تحت حكم الإِمبراطوريَّة العثمانيَّة الجائر والظَّالم والكارثيِّ على شعبي وبلادي، أَي قبل قرن من الزَّمن من كارثة ونكبة فلسطين..
حين سأَل بطل الرِّواية أَنيس، ذو الصَّوت الشَّجيِّ العذب، صديقه الصَّدوق الفرنساوي أَنطوان عندما كان معه في باريس ورأى الجماهير الغفيرة تَسير في المظاهرات وتَهتف الهتافات بالأَصوات التي تَصل الغمام وتَرفع اليافطات فوق الرُّؤوس، ما هذا، قال له: إِنَّها الثَّورة، ولم يفهم عليه، ما معنى الثَّورة، يسأَل “قمت وسأَلتو وأَنا مُحرج شوي إِنِّي مش فاهم عليه إِيش يعني ثورة بالعربي..الثَّورة بالعربي يعني زي طوشة كبيرة آخرها دم كتير وأَحيانًا يبقى الملك أَو يرحل الملك ليحُلَّ محلَّه ملك جديد أَو مجانين جدد”(ص 130)، “وهاي آخرتك يا أَنيس هربت من يافا عشان تموت طخ بطوشة في باريس لا ناقة لك فيها ولا بعير زي ما بحكوا بالفرنساوي”(ص 158)، يقول له فيكتور فرنكشتاين “ثورة دي كلمة جديدة وهي ترجمة للثَّورة بالفرنساوي والثَّورة سي أَنيس إِذا ما كَنَتشِ جاهزة وقويَّة مش هاتغيَّر حاجة.. بالعكس هاتقلب كارثة ما بعدها كارثة.”(ص 177).
“فأَنا شاركتُ في الثَّورات السَّابقة التي بدأَت بأَحلام ورديَّة وانتهت بكوابيس مريرة”(ص 190).
تنتفض باريس بثورة ضدَّ الظُّلم ويطيحون بالملك الطَّاغية منتصرةً وبلادي ما زالت ترزح تحت الحكم العثمانيِّ البغيض اللئيم دون أَيِّ حركةٍ مناوئة له، ذليلةً..
“أَينما يعيشُ الملك تعيش الثَّورات والتَّظاهرات والإِضطرابات”(ص 210)..
يقومون بالثَّورة في باريس ونحن لا نعرف ماذا تعني كلمة ثورة ونحن
نرزح قرونًا تحت ظلم وبطش العُصملِّي، ولا نعرف ما هي الكاميرا “كامرا؟ إِيش يعني كامرا؟”(ص 49)..
تقول ماريان صاحبة أَنطوان: “السِّيادة الشَّعبيَّة تعني أَن نكون ما نريد دون أَن نعبثَ بما نريد..ويجب أَن تتمتَّع الثَّورة بعقلٍ جامعٍ وقادرٍ على تجسيد مبدأ السِّيادة في الأُمَّة”(ص 181).
الفرق بين حضارتين..
“أَنيس إِبن إِبراهيم إِبن حنَّا البياراتي”(ص 14)، من يافا، الذي وُلد “في عام القحط والجراد..”(ص 19)، ويقال إِنَّ من وُلد في هذا العام لحقته اللعنة، “فمن وُلد في عام الجراد سيغدو قحطًا أَينما حلَّ، لعنات، مآزق، خيبات تعصف بعمرهِ العشرينيِّ اليانع”(ص 101).
اسم رواية “مِحنة المهبولين” يأتي في قول أَنيس (ص 240):”وما أَغاظني وخيَّب أَملي أَيضًا في تلك اللحظات هو غياب مُهجة وعدم مساندته لي في محنتي المهبولة منذ أَن عثر على كتبه مندغمًا بها”..
اتُّهم أَنيس بقتل فتاة تعمل في “خان النِّسا الفواحش” أَو خان “حبايب قلبي” (ص 40) أَو “خان التَّعريص في أَبو كبير”(ص 56)، عند البطرونة سهير المصرية، في بيت للدَّعارة، بعد أَن قضى ليلة ماجنة مع فتاة من “حبايب قلبي”، قبل ليلة من قتلها حيث اتَّهمه بهذا العمل الإِقطاعيُّ جورج سمير إِمطانس، عند الصُّباشي (رئيس المخفر)..
“أَنيس يترعرعُ في أَملاك وبيَّارات سمير إِمطانس، برفقة شقيقة جورج الصُّغرى والوحيدة مريم.” (ص 19). “مريم قلب أَنيس وبرتقالته العطرة، وهي السَّبب الخفيُّ لكلِّ ذلك الحقد المستعر في قلب أَخيها جورج على أَنيس الذي لا يوجد في قلبه سواها هي..مريم”(ص 19)، مريم التي “هَبْلَتك وعمَت قمار قلبك وراسك”(ص 28)..
ويُطلَبُ أَنيس للعدالة..
حيث نَسج له ابن كبير تجار يافا تهمة القتل، انتقامًا منه لصداقته مع اخته مريم، ولأَنَّه مقتدرٌ ذو سطوةٍ استطاع شراء ذمَّة بعضهم، وبالأساس سهير صاحبة “الكرخانة”، وشهدوا ضدَّه، فهرب البريئ أَنيس من العدالة إِلى خالته ماريَّا في رام الله، بطلب من والده، ريثما تهدأ الاُمور، حيث كان هناك موسم جداد الزَّيتون، “السَّنة سنة الزَّيتون ماسِيهِ والله وشَّك خير علينا يا أَنيس”(ص 70)، إِذ السَّنة الماضية كان الموسم شحيحًا “السَّنة هديك كانت شلتونة فش فيها خير كتير”(ص 70).
مكث عند خالته ماريَّا كلَّ موسم جداد الزَّيتون دون أَن يُخبرها عن سبب وجوده عندها كلَّ هذه المدَّة، ولم تسأَله، ومن بعدها انتهز فرصة عيد الأَضحى حيث يذهب رجال رام الله إِلى القرى المجاورة لتهنئة الأَصحاب والخلان بالعيد، وكذلك تحضيرات عرس كرَّام ابن خالته ماريَّا، “وعجقة العرس” إِلى الهروب من رام الله ليعود إِلى يافا.
لكنَّ الأُمور لم تهدأ..
ترك أَنيس يافا ورام الله ورفض تسليم نفسه للصُّوباشي، رئيس المخفر أَو لرأس الميري، الحكومة، بعد أَن أَنكره والده ورفض لقاءه، مع أَنَّ والده يعرف أَنَّ أَبنه بريئ من دمها، حينها وجد بأَنطوان الفرنساوي صديقه الوحيد “طوق نجاته وهو الشَّخص الوحيد الذي باستطاعته المساهمة في إِنقاذه من دوَّامة المصيبة والفضيحة” (ص 107)، وفي مكان آخر يقول أَنيس “ولكنَّنِي أَعرف بلادي جيِّدًا. بلادُك أَخذت منِّي مريم”(ص 117)، أَخذت منه مريم، أَخذت منه مريمه، كيف يكون ذلك! طوق الخلاص عند الفرنساوي والفرنساوي أَخذ منه مريمه..
يقول أَنيس “مريم دواي، وبرتقانتي، وهواي، مريم هي يافا ويافا هي مريم”(ص 178).
يجد في الأَجنبيِّ خلاصه وملجأَه، بعد أّن أّنكره والده “قولُّو أّنيس مات”(ص 114)، ولم يلقَ الدَّعم من والده ولا من أَشقَّائه..
“كم كُنتَ وحيدك” يا أَنيس، أَنت بريئ، من دمها يا أَنيس..
أَنيس بريءٌ براءة الذئب من دم يوسف..
ويهاجر إِلى باريس مع صديقه التَّاجر أَنطوان..
يهرب من رام الله عائدًا إِلى يافا ثمَّ يمخرُ عباب اليمِّ إِلى باريس بدون أَوراق ثبوتيَّة، حيث قام صديقه أَنطوان، بتهريبه في صناديق حجَّاج بيت المقدس، التي لا تُفتَّش عادةً، ريثما تصل مرسيليا بحرًا ومنها إِلى باريس برَّا، حيث تسكن فيها مريم حبيبته، في قصر على مقربة من قصر فرساي، زوَّجوها من تاجرٍ فرنسيٍّ غنيٍّ، وسكَّنوها هناك، عبر البحار..
ويُغنِّي أَنيس: يمَّا يا يمَّا حبيبي وينو حطُّولي البحر ما بيني وبينو(ص14)
قرَّر أَنيس الهروب إِلى باريس ليلتقي بمريمه وكأَنَّ باريس كفُّ يده، وهذا هو الحلم والهبل، روح دوِّر ع مريم في باريس، أَمَّا صديقه مهجة القلب اسماعيل المحاسب ظاظا فيترك مصرَ ليُفتِّش عن كتبٍ مخبَّأَةٍ في قصر فرساي، كان الفرنساوي قد سرقها من مكتبات الأَندلس لابن رشد وغيره “هي دي الوصيَّة..العلامة قال لسيدي الشَّيخ إِنَّ الفرنساويَّة أَخذوا كتب كتير من كتب الحكما والعلما اللي كانوا عايشين بغرناطة وأَشبيلية وقرطبة قبل تمنُميت تسعُميت سنة وخبُّوها في كتبخانات الملوك والأُمرا وفادتهم بالمُلك والحكم”(ص 174)، هذا يفتِّش عن حبيبته في باريس وذاك يفتِّش عن كتب أَندلسيَّة في قصر فرساي وذلك الشَّيخ يبعثُ تلميذه للبحث عن كتبٍ في قصر فرساي بباريس، في ظرفٍ فرنسيٍّ صعبٍ، ثورة فرنسيَّة، ثورة “ربيع شعوب” أُوروبا..
قال عنه والده إِبراهيم مرَّةً “بس إِنتا كنت مهبول”(ص 28)، والمهبول الثَّاني مهجة القلب اسماعيل الحاسب ظاظا من مصرَ، تلميذ الشَّيخ عبد السَّميع الأَطرش وهو المهبول الثَّالث..
لقد كانت محنته المهبولة التَّفتيش عن عشيقته مريم في باريس..
علَّه يجدُ ضالَّته..
حبٌّ كبيرٌ يجمع بين مريم إِبنة الإِقطاعيِّ سمير إِمطانس وابن الفلاح الأَجير عند هذا الإِقطاعيِّ أَنيس ابراهيم حنَّا البيَّاراتيِّ، انتو مين واحنا مين، لقد علَّمته مريم اللغة الإِفرنسيَّة بعد أَن أَدخل إِلى قلبها البسمة والغبطة والسُّرور.
“وين أَلقاب أَبوك خواجا أَنيس، مين إِنتا؟!..ولا إِنتا مين وإِبن مين يلا إِنصرف ع شغلك.”(ص 21)، “وجورج لا يقوى على استيعاب أَنَّ هذا العجوز وأَبناءه كانوا أُجراء لدى عائلته..”(ص 18)، وقد أَصبح ملاكًا بعد جهدِ وكدِّ والد أَنيس، إِبراهيم.
إزدهر وضع ابراهيم حنَّا البيَّاراتي المادِّيُّ وأَصبح بحالٍ جيِّدة يُضاهي به الإِقطاعيَّ سمير، أَو يكاد، في امتلاك بيارتين في يافا، “..حصل على بيَّارتين كبيرتين من حُرِّ تعبه وماله وعرق جبينه.”(ص 18)، لكنَّ هذا الأَمر لم يشفع لأَنيس..
إِنَّه صراعٌ طبقيٌّ بين الإِقطاعيِّ والفلاح والأَجير، وبين أَصحاب رؤوس الأَموال أَنفسهم يتنافسون بين بعضهم البعض..
أَنيس البيَّاراتي ابن يافا يعتزُّ ويفتخرُ بانتمائه، “أَنا من يافا..يافا بتسوى الدِّنيا”(ص 200)، أَنيس إِنسانٌ شهمٌ ذو مروءة ونخوة وعزَّة نفس ينصر ويدافع عن المظلومين والمضطَّهدين والضُّعفاء والمقهورين..
قلب أَنيس “..فقلبُك عزمُهُ شديدٌ وعزيمةُ القلبِ لا تُهزمُ”(ص 240)..
حين انقضَّ شابَّان ثملان، في يافا، على أَنطوان ابن جاك بليزيه التَّاجر بغية سرقته بعد يوم بيعٍ ناجحٍ، في توريد أَطنانٍ من القمح، إِنقضَّا عليه ووجدا معه الذَّهب والفرنكات، دبَّت الحمِيَّة والعزم والنَّخوة في قلب أَنيس، مع أَنَّه لا يعرفه، “حيث انقضَّ أَنيس بخنجره على الشَّابَّيْن المخموريْن ساعيًا في إِخافتهما وردِّهما عن مسعاهما فنجحَ في ذلك وسط عجزِ وحيرةِ الشَّاب الفرنساوي..” (ص 37).
لقد أَصبحا صديقين صدوقين، الشَّاب اليافيُّ والتَّاجرُ الباريسيُّ..
حين وصل أَنطوان وأَنيس العاصمة باريس سكن أَنيس في نُزُل جدِّ أَنطوان، وهناك سكن مع ثلاثة شبَّان من مصرَ، صبحي، تحسين ومهجة القلب اسماعيل الحاسب ظاظا. وبدأَ صبحي وتحسين “بالهراء..والسَّماجة والوقاحة والزَّناخة التي تفوق زناخة السَّمك..” (ص 147)، والظَّاهر أَنَّهم كانوا يضطَّهدون ويتزانخون على مهجة، الأَمر الذي شعره أَنيس من اللقاء الأَوَّل. يقول أَنيس: “قمتُ عن المقعد هائجًا مائجًا وفتحت بقجة ملابسي وبحثتُ فيها إِلى أَن وجدتُ ضالَّتي خنجري ورفيق دربي..وهرعتُ منقضًّا نحو تحسين، وقبضتُ عليه من رأسه ووضعت الخنجر على رقبته..فأَخذ يرتجف من شدَّة الخوف.. ووطأَة مباغتتي له”(ص 148)..وهكذا نصر أَنيس مهجة القلب المظلوم.
وحين كان أَنيس ومهجة يسيران في شوراع باريس التقيا بفيكتور فرنكنشتاين (بطل رواية فرنكنشتاين برومينيوس الجديد للكاتبة البريطانيَّة ماري شلي)، حيث طلب منهما مساعدته “يا ريت لو تساعدوني يا سي الأَفندي أَنا مقطوع من شجرةٍ وما عرفش حدِّ هِنا”(ص 161)، وكان فيكتور يأكل الورق ويعتاش من أَكل الورق، ولا ينام، مقطوع من شجرة، فقيرٌ ومُضطَّهدٌ من الغلابى، فهرَّبوه معهم إِلى مسكنهم، نُزُلهم قائلاً “لازم نساعدو..فأَشفقنا عليه وعلى حالته المزرية..”(ص 162)، فيكتور يتكلَّم المصريَّة لكنَّه لم يكن مصريًّا، لكنِّي لا أَعرف، ما هي غاية الكاتب، لا أَعلم، ربَّما تحت تأثير الوضع، في لجان المفاوضات. وانتقل أَنيس مع مهجة وفيكتور إِلى مسكنٍ جديدٍ ولم يرضَ أَن يسكن بدونهما “وزَي ما بحكوا بالعربي لسَّا الهبل بأَوَّلو”(ص 171)..
بعد أَن ذهبوا إِلى فرساي لتحرير كتب الأَندلس إِلى أَصحابها العرب، كُتُب ابن رشد، وابن حزم، وأَبي حامد الغزاليِّ ونجحوا في دخول القصر وحرَّروا الكتب بمساعدة فتاة فرنساويَّة تمَّ تعويضها مادِّيًّا، التقوا بجان فالجان، الذي كان شاردًا بلا مأوى، فآواه أَنيس عنده (جان فالجان هو بطل رواية البؤساء للكاتب الفرنسيِّ فيكتور هوجو)، بعد أَن ساعدهم حين حادَت العربة عن طريقها وغرَّزت العجلة في حفرة ضخمة مليئة بمياه الأَمطار في الشَّارع، ونجحوا في تخليص العربة وإِعادتها إِلى مسارها فأَخذه معه “وكأَنُّو الطُّنبر طُنبر أَبوي وباريز حارة من حارات يافا”(ص 185)..
مرَّةً، خلال سفرهم بالطُّنبر نهارًا وجدوا في طريقهم “امرأَةً متكوِّمةً فوق الرَّصيف فخفق قلبي بشدَّةٍ، وخشيتُ من أَن تكون العربة قد صدمتها” (ص 191). كانت المرأَةُ شابَّةً مخمورةً، رائعةَ الجمال، فاتنةَ القدِّ، بهيَّةَ الطَّلعة بشعرها الحريريِّ ووجنتيها الورديَّتين وصدرها العامر وشفتيها الرَّقيقتين، كانت هاربةً من زوجها، من الحياة المملَّة معه والخانقة حيث أَراد قتلها بدسِّ السُّمِّ في طعامها، فطلبت من أَنيس اللجوء إِليهم، وكان لها ما أَرادت، كان اسمها إِيما بوفاري (بطلة رواية مدام بوفاري للكاتب الفرنسيِّ جوستاف فولبيير).
يستحضر كاتبنا باسم خندقجي شخصيَّات وردت أَسماؤها في الأَدب العالميِّ كالكاتب الفرنسيِّ فيكتور هوجو في روايته “البؤساء” عن جان فالجان والمفتِّش جافيير، والكاتب الفرنسيِّ جوستاف فولبير في روايته “مدام بوفاري” عن إِيما بوفاري، ورواية الكاتبة البريطانيَّة ماري شلي “فرنكنشتاين أَو برومينيوس الجديد” عن فيكتور فرنكنشتاين، يجنِّدهم معه من أَجل قضيَّته العادلة..
يا عمَّال العالم اتَّحدوا ويا أَيَّتها الشُّعوب المضطَّهدة اتَّحدي ضد الظُّلم والطُّغيان والحرمان والفقر والاضطِّهاد..
بينما يستحضر كاتبنا محمود شقير في روايته “منزل الذِّكريات” لعبة الأَحلام المتناصَّة الكاتب الكولومبيِّ جابرييل غارسيا ماركيز في روايته “ذكرى غانياتي الحزينات” والكاتب الياباني ياسوناري كاواباتا في روايته “الجميلات النَّائمات”..
نتعرَّف في الرِّواية على يوم عيد “أَربعاء أَيُّوب”..
إِذ تقول له أُخته سوسن في موسم “أَربعة أَيُّوب” أَو أَربعاء أَيُّوب ذلك العيد الذي به يُشفي المرضى وتتحقَّق الأُمنيات مهما كانت صعبة المنال، فالعزباء التي تُفتِّش عن عريس وتجده، والمتزوِّجة تسأَل الله بأَن تحبل فتحبلُ وتُنجب، أَراد أَخذ أُخته وهي عاقر إِلى مقام النَّبيِّ أَيُّوب ليشفع لها، لتحبل وتُنجب، قالت ساخرةً منه “ولك إِنتا أَهبل؟” (ص 33)..
حيث كانت النسوة هناك تُغنِّي (ص 33):
يا بحر جيتك دايرة من كثر ما أَنا بايرة
كلُّ البنات اتجوَّزِت وأَنا على شطَّك دايرة
قصَّة الصَّناديق..
حتَّى يستطيع أَنيس السَّفر مع التَّاجر الفرنساويِّ الكبير صديقه إِلى باريس للقاء مريمه، كان عليه الإِبحارُ إِلى ما وراء البحار بأَوراق ثبوتيَّة، التي لم تكن موجودةً معه، أَصلاً، لذلك هرَّبه صديقه الصَّدوق في صندوق، وضعه في بطن السَّفينة، ريثما يصلان ميناء مرسيليا، على أَن يُحضر له الزَّاد والماء، الطَّعام والشَّراب بين الحين والحين، ويوميًّا..
وهنا استذكرُ وضَّاح اليمن حين كانت تُخبِّئه حبيبته روضة زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك، في صندوقٍ، داخل غرفتها في القصر، دون علم الخليفة، ليتشبَّب بها ويُغازلها ويُداعبها ويُدلِّلها، لكن عندما اكتشف الخليفة أَمر وضَّاح، بعد أّن وشى به خادمه، قام وأَخرج الصُّندوق من دارها ودفنه حيًّا وهو في الصُّندوق، فوجد حتفه في الصُّندوق، لقد كان وضَّاح مخلصًا لعشيقته حريصًا على “عفَّتها” دون أَن ينبس ببنت شفة، رغم معرفته بموته..
فستر الخليفة حاله من الفضيحة وكظمَ وضَّاح السِّرَّ وستر على روضة ومات فداءً لها..
لكنَّ أَنيس يجد خلاصه في الصُّندوق ذهابًا لباريس ليُفتِّش عن عشيقته، مريمه، التي لم يجدها وإِيابًا إِلى يافا، إِلى الوطن، دونها عساه يلقاها فيكون قد انتصر على الإِقطاعيِّ سمير إِمطانس، مع ثلاثة صناديق، هم عدد مؤبَّداته في سجون الإِحتلال، وفي كلِّ صندوق صديق من أَصقائه الذين تعرَّف عليهم في باريس، فيكتور وإِيما وجان فالجان..
ينصرونه ويدعمونه في عودته إِلى يافا..
خلاصه في الصُّندوق، حين يصل إِلى يافا ويخرج من الصُّندوق ويجدُ حرِّيَّته، مهما طال زمن السَّفر ومهما كانت الأَنواء عاتية، ساعة العودة إِلى يافا قد حانت أَكيدة..
إِذا لم أَحترق أَنا
وإِذا لم تحترق أَنتَ
وإِذا لم نحترق جميعًا
فمن ذا يُبدد الظَّلام؟
“فش حل تاني صديقي أَنيس..لازم نرجع عَ يافا ويجوز هناك تلتقي بمريم”(ص 246)..
مريم هي يافا ويافا هي مريم..
“وَلَك مريم عين السِّتَّات وزُبدة الجواهر الجميلات وزينة بنات ملَّتها ودرَّة تاج أُسرتها وأَميرة قلب عاشقها وبرتقانة يافا وبيَّارتها”(ص 243).
“والسَّلام عليك يا مريم”
“والسَّلام منك..”
“والسَّلام إِليك..”(ص 246)..
وعليكِ منِّي السَّلام يا أَرض أَجدادي..
ختامًا..
تبريكاتي القلبيَّة العطرة للكاتب الفلسطينيِّ ابن مدينة نابلس، ابن جبل النَّار، الذي وُلد عام أَلف وتسعمائة وإِثنين وثمانين، وهو خرِّيج كليَّة الصَّحافة والإعلام، أَسير منذ العام أَلفين وأَربعة، حُكم عليه بالسِّجن بثلاثة مؤبَّدات، مدى الحياة، وهو عضوُ في اللجنة المركزيَّة لحزب الشَّعب الفلسطينيِّ، الشُّيوعيِّ سابقًا، على أَمل التَّحرير والإِفراج القريب..
أَعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ وَخَيْرُ جَلِيسٍ في الزَّمانِ كِتابُ..
ملحوظة: صدرت هذه الرِّواية، عام أَلفين وأَربعة وعشرين، عن مكتبة العم صالح، نابلس فلسطين، تنسيق داخلي نضال خندقجي، لوحة الغلاف نسرين أَبو عليا، تصميم الغلاف دانا الكخن، والكتاب من الحجم المتوسِّط، في مائتين وخمسين صفحة..
ملحوظة ثانية: أَربعة أّيُّوب أَو أّربعاء أّيُّوب هي مناسبة روحيَّة وشعبيَّة مرتبطة بقصَّة النَّبيِّ أَيُّوب وصبره على الشَّدائد، وتتضمَّن طقوسًا خاصَّة مثل الإِغتسال في البحر أو المياه المقدَّسة والدُّعاء، فالعاقر تحبل، والمريض يُشفى، والمحتاج يُلبَّى طلبه، في هذا العيد إِقرع يُفتح لكم..والله أَعلم..
ملحوظة ثالثة: الخندقجي هو العامل في حفر الخنادق والتَّحصينات، مكوَّنة من الخندق، كلمة عربيَّة، جي هي كلمة تركيَّة وتعني مهنة أَو حرفة..
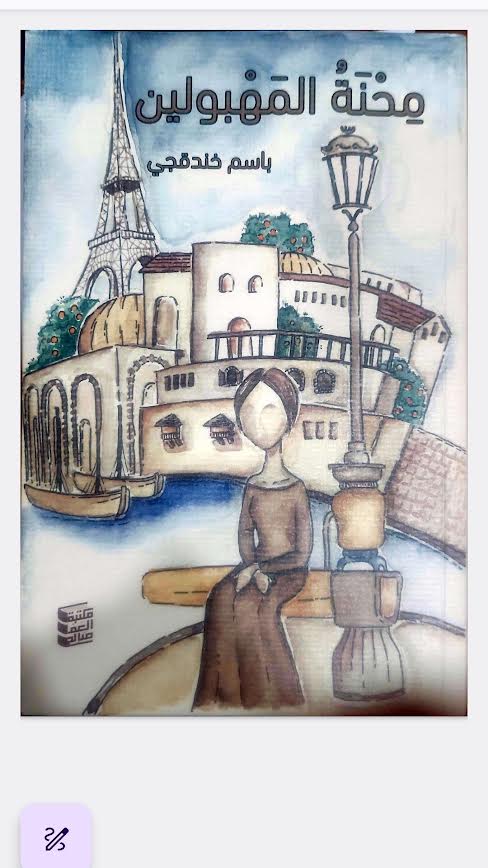
تعبّر هذه المواضيع المنشورة عن آراء كتّابها، وليس بالضّرورة عن رأي الموقع أو أي طرف آخر يرتبط به.